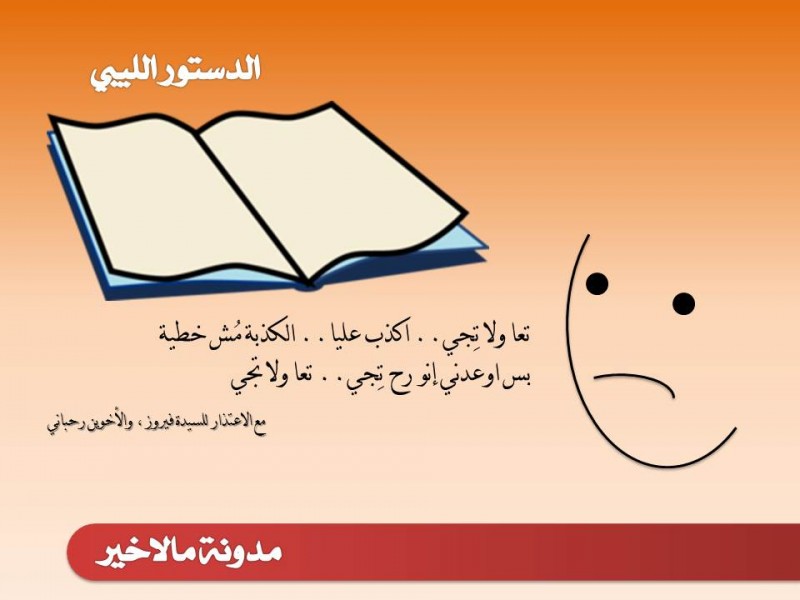الشأن الليبي

تدوينة صوتية: حقوق المستهلك

تعليق.. بنتك وزيد عصيدة
(إعطي بنتك.. وزيد عصيدة)
عنوان مقطع فيديو انتشر على النت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص (الفيس بوك)، ولأن الموضوع يتعلق بالليبيين، تحول هذا الفيديو إلى شغلهم وملتقى تهدريزهم وشدهم ورخيهم. خاصة وإن الموضوع يمس الشباب الليبي بشكل مباشر.
بطل المقطع هو شاب ليبي اسمه “وليد الأعوج”، ولا أعرف إن كان هو اسمه الحقيقي أم لا؛ لكن يبدو إنه مقيم أو موجود بأحد الدور الأوربية، ومن خلال تسجيل مصور، يتحدث عن الزواج في المجتمع الليبي، طالباً من الأهل أن يعطوا بناتهم ويزيدوا عصيدة، ويرضوا.
أثار هذا المقطع، الكثير من ردود الأفعال، والنقاش، بين مجتمع الشباب الليبي، بين معترض ومؤيد لما جاء في المقطع، أما البنات الليبيات فالغالية اعترضن. وكحركة مقاومة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من أشكال الرفض، في شكل صور للسيد “وليد” متزوجاً من (لامبه) وهو الوصف الذي أسقطه على فتيات أوروبا، بعد أن نصح الشباب بالزواج منهن، أو من خلال بعض المقاطع المضادة.
“وليد” بدأ سلسلة مقاطعه المصورة، من المشاكل التي يتعرض لها الشاب الليبي عند الرغبة في الزواج من أجنبية، والتعقيدات التي تقابله في السفارات، ومن داخل البلاد. ثم انتقل بالحديث عن مشكلة الزواج من الليبيات في مقابل الزواج من أجنبية، بمقياس الميزات والعيوب.
ما أريد قوله؛ إننا كمجتمع مازلنا نفتقر لأهم أساسيات الحوار وطرح القضايا. فنحن نطرح قضايانا بسطيحة، وبمجانية مقيتة. فلا هتم بدراسة المسألة أو القضية، ومحاولة الوقوف على أهم النقاط، ومن بعد مناقشتها وعرضها بشكل منهجي أو حيادي، برغبة البحث عن حل، مما يعني قبول أي رأي مع أو ضد.
فالكثير من القضايا التي تم طرحها عن طريق الشبكة؛
– عرضت بشكل سطحي، ومجاني، أي لم يعد لها بشكل جيد، إلا ما ندر. وهذا ينسحب على القضايا الاجتماعية والسياسية، وغيرها. إذ لا خطوط عريضة أو نقاط رئيسية، أو مباحث.
– الحوار والنقاش، افتقد لأهم مسألة وهي الحياد، أو النظر للموضوع بحيادية، بعيداً عن تغليب المصالح الشخصية أو المرجعيات الاجتماعية والسياسية. الأمر الذي لا يجعل لهذا الحوار من مخرجات.
– لا قاعدة علمية أو حتى منطقية للحلول التي يتم اقتراحها، أو تبنيها، لأنها حلول تخدم المصلحة.
– التعميم، وهي من أهم المشاكل التي نجدها في أي حوار ليبي – ليبي، فأنت تتحدث باسم الكل وتدافع عن الكل، والطرف الآخر يعتمد على ذات الكل.
– القناعة المسبقة، أو النتيجة المبيتة؛ فالملاحظ إن أي ليبي موجود في حوار، أو نقاش حول قضية ما، يكون لديه حكماً مسبقاً أو قناعة ما، أو نتيجة مبيتة في نفسه، يقوم بعرضها والدفاع عنها، وفرضها.
إن “وليد الأعوج” إنما يعرينا لا أكثر.
فلو نظرنا للمسألة بشكل مجرد، وهي الزواج، لوجدنا إنها قضية قديمة، قدم المجتمع الليبي، وأن المجتمع أوجد لها حلولاً تواطأت فيها جميع الأطراف، وبعض المسائل صارت من التاريخ، ومن الأمور المستهجنة، يعني (كل قدير وقدره)، و(مادامكم متفاهمين، ربي يبارك)، و(اللي بتجيبه بيقعدلك)، و(بنديروا الماير)، و(المهم راجل)، و(البنت بنتكم)، و(لا نبي لا دهب ولا غيره، المهم مكان يلمكم). ربما مسألة (البيت) هي العقدة الأخيرة في مسلسل قضية الزواج في ليبيا، وهي مسألة وطنية على الدولة تحمل دورها في هذا الأمر.
مجتمعنا الليبي بخير، مجتمع حي، إنما يحتاج لدعم الدولة، ومن قبلها الاستقرار.
*
حفظ الله ليبيا

احذرو التقليد (إسطوانات غاز الطهي)
تنتشر في ليبيا وفي مدينة طرابلس -بشكل خاص- إسطوانات لغاز الطهي، مقلدة وتباع بسعر عال، وهي غير معتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.
وهذه مشاركة من الأخ (جمعة الترهوني) نشرها على حسابه في الفيس بوك، نقلها هنا للفائدة.
هناك أنابيب غاز تباع في السوق الليبي وهي تعتبر مزورة ولا تقع تحت طائلة مسؤولية شركة البريقة وهي ليست مصنعة حسب المواصفات القياسية القانونية المعتمدة من شركة البريقة، حيث حدثت لأحد الأصدقاء مشكلة بعد أن اشترى واحدة من تلك الأنابيب من أحد محلات بيع الغاز (محل خاص) وبعد أن استعملها وتم استهلاكها ذهب كعادته لاستبدالها عند أحد مستودعات الغاز التابعة لشركة البريقة، فرفضوا استلامها بحجة أنها غير أصلية، فما كان من صاحبنا إلا أن رجع إلى صاحب المستودع الأول الذي تم استبدالها عنده فاسترجعها ولكن بجهد جهيد ، وبعد أن تدخلوا أهل الخير …)
(عذرا لركاكة صياغة الإعلان لفداحة الأمر .. فحتى النار لم تسلم من التزوير والسمسرة).. ومع هذا كله احذروا التقليد … احذروا الحرايمية … احذرووووووووووووووووووا
(1) غير أصلية
(2) أصلية …

ليبيون
حكايات ليبية
تستدعي ذاكرتي في هذه الأيام، وبشكلٍ كبير، ذكرياتي طفولتي الأولى ومرابع صباي بمنطقة (تقسيم التواتي) بـ(حي المنشية – شارع بن عاشور)، وبشكل خاص العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط سكان الحي. والذين شاء القدر أن يكونوا خليطاً محلياً وعربياً وأجنبياً، تعايش في سلام، ورسم مشاهد لازلت في ذاكرتي، ولن تغيب.
الحي كان مستطيل الشكل، في مستويين؛ المستوى الأول اصطفت فيه البيوت على المحيط الخارجي لهذا المستطيل، أما الثاني فتراصت في على جهتين في مستطيلٍ داخلي. حتى الثمانينيات، كانت الشوارع ترابية، وكنت نستمتع بغدران المطر، وحفر بوكات البتش، وفن الزرابيط، قبل أن تدخل الشركة التركية، وترصف الشارع بالأسفلت، وتحفهُ برصيف، اخترعنا على أساسه لعبة جديدة تستخدم فيها الكرة، أسميناها (الحاشية). كان هذا المستطيل يطل في واجهته الشمالية على الطريق العام، وتحفه شرقاً وجنوباً السواني (الكرداسي، بن سعيدان، الكانوني، القصبي،…) أما غرباً مربعٌ سكني آخر.
في ليالي الصيف، كان الطريق العام يتحول لساحة لعب، كونه البقعة المضيئة. أما السواني، فكانت ملعبنا في اصطياد العصافير بنصب (الطربيقة) أو (الكولّا) أو استخدام (الفليتشا)، والتسلق أشجار التوت. كانت أي مساحة مربعة تتحول إلى ملعبٍ لكرة القدم.
تشارك هذا الحي مجموعة من العائلات الليبية، والعربية، ولأني تحدث عن العائلات العربية في حديثٍ سابق، أركز هنا في حديثي عن العائلات الليبية، التي عشتُ جنبات بيوتاتها، وأكلت خبزها وتذوقت ملحها.
كان بيتنا في الركن الشرقي من المستطيل الخارجي للحي. وأقرب الجيران لنا، كانت عائلة (جبالية)، وهي أول ما أتذكر من العائلات، وكانت مكونة من زوج وزوجة، لا أتذكر الكثير عنهم، كونهم غادروا الحي مبكراً، لتحل محلها عائلة من ذات الجبل، كانت ذات إيقاع حياتي خاص لكثرة زوارهم من الجبل، ولتواصلهم الرائع مع كل الجيران، حتى اللحظة بعد مغادرتهم الحي.
أربعُ عائلات من (مصراتة) عن يميننا وشمالنا، تميزت أعراسهم بـ(الزكرة) و(التمر)، أما العيد الصغير (عيد الفطر) فكان لا يتم إلا بالفطيرة المصراتية.
على ذات الخط، كانت تسكن عائلة من فزان، لا أستطيع أن أصف مقدار طيبة هذه العائلة، التي كانت توزع التمر في مواسمه على الجيران. ولشد ما لا تمل حديث جارنا مستمتعاً بلهجة أهل الجنوب المميزة.
في المقابل سكنت أحد عائلات الساحل، الزاوية الغربية؛ كانت رائحة الكسكسي الذي تصنعه جارتنا يعبق في الحي، واليقين أن (الذوقة) هذه المرة نصيب أحد البيوت. على ذات المسار عائلة من تاجوراء، ثم زليطن، غريان. أضافة للعائلات الطرابلسية، أو العائلات التي سكنت طرابلس من القديم، والتي تميز بصنع الحلويات الطرابلسية كــ(الكعك المالح)، و(المقروض)، أما (البكلاوة) فمذاقها لا يغادر فمي حتى اليوم.
وكما كان لكل بيت بصمته الخاصة، كل لكل بيت ما يتقاسمه وجيرانه، في اليومي والمناسبات حلوها ومرها. مع السنوات كانت بعض العائلات تغادر، لتحل مكانها أخرى، فسيفساء متواشجة في لبنات لجسدٍ واحد اسمه ليبيا. في المراحل المبكرة من عمري، كان الكل سواء، كلنا ليبيون، وإن اختلفت ألواننا أو لهجاتنا، الانتماءات كانت تظهر بشكل واضح في الأعياد، عندما يفرغ الشارع فجأة من أغلب قاطنيه –وكنا منهم-، متجهي إلى بلدتنا للمعايدة وقضاء يوماً أو يومين مع الأقارب.
كنا نعيش كأنا أسرة واحدة، نمارس حياتنا بشكل متناغم، لا معنى فيها للقبيلة أو الانتماء لمدينة ما، أو جهة ما. نرقص على إيقاع الزكرة المصراتية بذات الحماس على إيقاع تدريجة العريس، وبذات الحب نواسي بعضنا في المصائب والملمات. كانت كل البيوت مشرعة، وكأن كل منها غرفة في بيت.
عندما مرض أبي –وأنا لازلت صغيراً- ذات ليلة، قصدت بيت جارنا، الذي هرع لنجدتنا، وحمله إلى المستشفى، وقالي: وللي للحوش. ليعود صباحاً، بحضور زوجته وهمي تطمئننا عن صحة الوالد، وأن ما مر به عارض. هو ذات الموقف الذي لجأت فيه جارتنا لبيتنا، في 15-4-1986 عندما قُصفت طرابلس، ليحول جارنا (ريفوتجو) إلى ملجأ لعائلات الحي، خلال فترة الطوارئ. وهو نفسه كان يهب صالته لإقامة الأفراح والأتراح.
لم أشعر يوماً بالوحدة في هذا الحي، فغير لعب كرة القدم، مارست هواياتي بكل حب أمام الأصدقاء والجيران، فكل الجيران كانوا يسألون عن رسوماتي، وتخطيطاتي، كما يتابعون تجاربي، حتى سميت بـ(عبقرينوا). كان ثمة من يشاركني شغفي بالكتب وقراءة الألغاز البوليسية، أو الغناء والعزف الذي برغم المحاولات فشلت فيه بامتياز.
لازال الحي كما هو، وإن تغير بعض الشيء، محافظاً على نسيجة الملون الرائع، برغم الحوادث.
حفظ الله ليبيا.